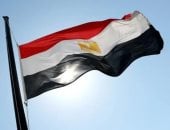100 يوم على رئاسة ترامب.. ولاية المشهد المكرر أو دراما بحلقات متصلة منفصلة

وصل ترامب إلى شاطئه الأوَّل. عتبة المائة يوم التى اتُّفِقَ بالمُمارسة على أن تكون مُهلةَ استقبالٍ وإيضاح ومُكاشفة، وفيها يُحدِّد الرئيسُ الجديد معالمَ إدارته ومشروعها، ويعرفُ الجمهورُ مفاتيح رؤيته وآليَّات الوصول إليها.
وعلى قِصَرِها البادى بالقياس إلى ولايةٍ من أربع سنوات؛ فإنها تصلحُ عَيّنةً استطلاعيَّةً للبرنامج وصاحبه، إذ تُمثِّلُ نسبةً تُقارب 8 % من العُهدة الرئاسية، وتشتمل بالحماسة والإقبال على أبرز العناصر الناظمة للتجربة المُنتَظَرة، وما يترجَّحُ التكثيف فيه أو تتضاءلُ احتمالات النظر إليه من الأساس.
وفى كلِّ ما يتوافرُ من سوابق وأرقامٍ واستدلالات عملية، يبدو أنها كانت الفاتحةَ الأكثر صخبًا بين كلِّ الرؤساء الأمريكيين، أو على الأقل الخمسة عشر الذين تتابعوا على البيت الأبيض منذ فرانكلين روزفلت، عقب الكساد الكبير وقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.
والعودةُ إلى ثلاثينيَّات القرن الماضى ليست مجّانيةً أو اعتباطية على الإطلاق؛ إذ كانت الولاياتُ المُتَّحدة وقتَها تخوضُ حربًا شعواء مع الاقتصاد واختلالاته العميقة، انتقلت منها إلى صراعٍ عالمىٍّ أكبر وأخطر، ومن مجموعهما خرجت أقوى وأكثر هيمنةً، ورسَّخت لمعالم القرن الأمريكىِّ الذى أُغلِقَ نظريًّا مع مطلع الألفية الجديدة، وفى الحسابات ما يزال مُتّصلاً حتى ما بعد الانتخابات المقبلة.
أمَّا وجهُ التشابُه بين المرحلتين؛ فينبُعُ من أنَّ السيد دونالد يُسَعِّرُ المواجهة من جهة التجارة والسلوكيات الحمائية، ويُمهِّدُ الأرضَ لصداماتٍ خَشِنَة ليست خارج دائرة الاحتمالات كُلِّها، ولن تُجتَنَبَ آثارُها؛ ولو أفْلَتَ الجميعُ فيها من طَوق النار. طبيعةُ المعارك متحقِّقةٌ فيها، وكلُّ الظروف مُتوافرة، وقوّة الرَّدع لا تكفى لتحييد كُلفة الحسابات الخاطئة.
أسبغَ الرئيسُ العائدُ من مقبرةِ الولاية الواحدة نكهتَه الشعبويَّةَ الصارخة على الحزب الجمهورى. يكاد أن يكون خصخَصَه لحسابه تمامًا، وأضفى مذاقًا لاذعًا على خطاب اليمين المُحافظ وممارساته.
وطوال مسيرته الهادرة على طريق العودة، بالغ الرجلُ فى الاستعراض، وأفرطَ فى التعهُّدات، وبعدما ملأ الدنيا وشغل الناس؛ فوجئ المُشايعون باختلاف حسابات الحقل عن البيدر، وفرح المُناوئون أو انزعجوا واستشعروا الخطر.
وتبدّت حالةُ السيولة التى لا تقبضُ على خناق واشنطن وحدها؛ بل وقع العالم بكامله فى أسرها، واحتُبِس فيها مع سياسىٍّ من خارج الكتالوج المعتاد، وبعيًدا عن تعقّل السياسة وخبراتها المُتراكمة، والجلىُّ أنه لا سبيلَ للإفلات من الكمين، ولن تتوقَّف طاحونةُ السنوات الأربع عن طحن الثوابت، وتفجير المفاجآت.
فى المُقاربة البسيطة؛ اقتحمَ نبىُّ العَظَمة الأمريكية الجديدُ فضاءَ المسرح من أضيق كواليسه، وأكثر خواصره هشاشة. عجوزٌ يُوشك أن يستوفى عقدَه الثامن، فرضَ نفسَه قبل ثمانى سنواتٍ على اللعبة المحكومة بمُحدِّدات راسخة لعقودٍ طويلة، وفشل فى تجربته الأُولى بكلِّ المقاييس واعتبارات الفرز والتقييم.
شعبوىٌّ إلى آخر مدىً مُمكن؛ لكنه يتشارك مُكوِّنًا ثوريًّا مع ألدِّ خصومه. فهو ليس مُمثِّلاً مِثاليًّا على قاعدة «الواسب» المُستقرّة: الأبيض الأنجلوساكسونى إنجيلى المذهب. كسرَها أوباما قريبًا بأصله العرقىِّ، وكيندى سابقًا بمذهبه الكاثوليكى مثل الرئيس الحالى، وشتّان بين الثلاثة قولاً وسلوكًا.
أمَّا فى المُحاكمة على مُجمَل الأعمال؛ فقد أحدثَ قلاقل عميقةً فى بِنية النظام وامتداداته الخارجية، وما يتَّصل بتمَوضُع الولايات المتحدة تحت سقف القُطبيَّة الواحدة، أو فى السباق المُحتدم وصداماته المُرجأة مع التنِّين الصينى.
ولايتُه الأُولى جمعَتْ المُتناقضات فى جديلةٍ واحدة، فمِن نَقض الاتفاق النووىِّ مع إيران إلى مُفاوضة حركة طالبان بوساطةٍ قطرية، ومن تبريد الأجواء مع كوريا الشمالية إلى اغتيال قاسم سليمانى فى العراق.
صفقةُ القرن التى اشتَقَّ بها مسارًا لتصفية القضية الفلسطينية، وتولَّد عنها الاعترافُ بضَمِّ القدس والجولان لإسرائيل، واصطناع الاتفاقات الإبراهيميَّة وفَرضها على عدَّة دول إقليمية.
حربٌ تجاريَّة مع الصين، وغرامٌ مُفرط تجاه بوتين، وتصعيدٌ ضد الحلفاء فى الناتو. يرقصُ فى جبهةٍ ويُلاكم فى غيرها، ولا تنتظمُ خياراتُه فى خيطٍ واحد؛ كأنه يرتجلُ المواقفَ والسياسات ارتجالاً، وتحت ضغط اللحظة وانفعالاتها، وكيمياء مُخِّه حسبما يبتدئُ يومَه صباحًا، أو تكون علاقته مع ميلانيا والعائلة الكبيرة.
مُنِعَ الرجلُ من الانفلات فى مُغامراته خلال الولاية السابقة، أو مَنعَ نفسَه من دون قصدٍ.. كان قليلَ الخبرة فى الإدارة والمُؤسَّسية، ولم يَبنِ طبقتَه الخاصة من الداعمين والمُؤمنين بدينه الجديد.
أحاط نفسَه بوجوهٍ شعبويَّة؛ لكنها لم تكُن من خارج فضاء الدولة، وقد وُلِدَت ولادةً شرعية وتدرَّجت داخل الأُطر النظامية. المهم أنهم كانوا أكثر وعيًا وانضباطا، وأقلَّ إقدامًا على الاجتراء ومُناطحة القِيَم والتقاليد الراسخة.
وبهذا؛ فقد توصَّل إلى بعض نواياه، وعُطِّلَ عن بعضها. أمَّا اليومَ؛ فإنه يَفِدُ على رأس السلطة مُحاطًا بفريق أحلامه، ولا صوتَ يعلو فوق الترامبية، ولا معيارَ للانتقاء والبقاء والمُغادرة إلَّا الولاء الكامل. وحده لا شريك له؛ ولا كوابح أيضًا.
بحسب الاستطلاعات؛ فإنَّ شعبيته تآكلت كثيرًا عمَّا كانت عليه إبان التصويت فى نوفمبر الماضى. نسبةُ الرضا عن أدائه فى أوَّل مائةِ يومٍ أقلُّ مِمَّا كانت فى ولايته السابقة، ومن أغلب الرؤساء السابقين، منذ بدأت تجربة القياس قبل ثمانية عقود تقريبًا. وما يزالُ على عهده القديم؛ ينفعل فيقول، وتُرسَمُ السياساتُ عبر نافذته على شبكات التواصُل الرقمية، وقد استفاد من أزماته السابقة مع تويتر؛ فخصخص عملية الاتصال كلّها من خلال منصَّته الخاصة «تروث سوشيال».
يُفاجئُ أعضاءَ إدارته بالقرار تزامُنًا مع الجمهور؛ لذا ليس غريبًا أن يتداول مُعاونوه للأمن القومى فى المسائلَ الحيوية عبر تطبيق «سيجنال»، وأن يُضيفوا صحفيًّا بالخطأ إلى تركيبةٍ تُشبه مجلس الحرب، ولا يُسألُ أحدٌ منهم عن الخطأ، ولا يخرجُ رَدُّ فعله الشخصى عن الدفاع المستميت. فإذا كان ربُّ البيت بالدفِّ ضاربًا!
عندما أُثير مشروع 2025، أو مشروع انتقال الرئاسة، علنًا خلال السباق الانتخابى. حدث أن أنكر علاقتَه به، وزعم أنه رآه فعلاً؛ إنما لم يطّلع عليه كاملاً.
الخطَّة المُعَدَّة من خلال مُؤسَّسة اسمها «التراث»، تُمثِّل طيفًا صُقوريًّا من الجناح شديد المُحافظة فى الحزب الجمهورى، تُجاهرُ برغبتها فى تفكيك بِنية السلطات الأمريكية وتوازناتها، وإعادة بناء البلد على مُرتكزاتٍ جديدة تمامًا.
قد يكون من قبيل المُبالغة أن نوصِّفَها بالشمولية؛ لكنها تظلًّ بعيدة أيضًا عن الليبرتارية فى طبعتِها الأمريكية الموروثة يمينًا عن يسار. وبعيدًا من اتِّصاله العميق بالفريق المذكور، واستعانته بمُستشارين ومعاونين من أعضاء المُؤسَّسة؛ فالقرينة هُنا أنه يسيرُ باتجاه الغايات نفسها؛ ولو تفاوتت الوسائل قليلا.
كأنه يمشى على الطريق إلى جمهوريةٍ مُغايرة لسردية «المدينة فوق الجبل»؛ بينما الفارق الوحيد عن المُطابقة الكاملة كوقوع الحافر على الحافر، أنه يمنحُ مسارَه الحثيث إليها مُسمّىً آخر غير ما اشتملت عليه الأوراق.
ينطلقُ الرجل من تصوّرٍ طوباوىٍّ عن نفسه، وشيطانىٍّ عن العالم. العمُّ دونالد يحتكر الحقيقة الصافية، وإذ يتحرَّرُ تمامًا فى النظر لمصالح الولايات المتحدة؛ فإنه ينتهك القانون لأجل تفعيل القانون، ويشيع المظالم إخلاصًا للعدالة المُطلقة.
هكذا يتصوَّر أنَّ واشنطن فريسةٌ فى مرتع الذئاب، وتستحقُّ ما يفوقُ الرقم واحد، وينبغى أن تكون الفوارق مع الآخرين أضعافَ ما يقدرون على تعويضه، أو يحلمون به.
وعلى تلك الحال؛ فإنه يُقارب الحاضر بذاكرةٍ ماضويَّةٍ عتيقة، فى الوقت الذى يفتتح فيه خصوماته من الآنىِّ المُجرَّد، وبمعزلٍ عن الزمن الطويل وتداعياته الثقيلة.
يستدعى سلفَه البعيد ويليام ماكينلى بنكهةٍ لا تخلو من نزوعٍ استعمارىٍّ، ويُؤاخيه مع امبراطورية مُنفلتة إنما داخل قيود مونرو ومبدئه عن الكون الغربى اللصيق، ويُبشِّر بعظمةٍ تستقيلُ لا من دعاياتها الرسالية فحسب؛ بل من التزاماتها الوجوبية الضامنة للعظمة أصلاً.
يُريد أنْ يأخُذَ ولا يُعطى، ويقفز على حقيقة أنَّ الحقوق تستدعى الواجبات معها بالضرورة، وإمَّا أن تتقدَّم على الجميع بتوازُنٍ شديد الدقّة والإحكام والتكلفة أيضًا، أو تكون الأوَّل بين مُتساوين مع قدرٍ من الشغب والمُناكفة الطبيعية، وإلَّا فالعداوةُ ظاهرةً كانت أو مكتومة، وما من بديلٍ رابع.
قد لا يكون الناخب الأمريكى مَعنيًّا بقضايا السياسة الخارجية من الأساس؛ لكنها تنعكس عليه وتُطارده فى محلات البقالة ومحطَّات الوقود وغيرها.
مُؤشِّرات الاقتصاد ليست إيجابيَّةً بالمرّة؛ حتى مع مُكابرة الرئيس وصخبه الزائد، فالدولار يُسجِّل أسوأ أداء منذ أربع سنوات تقريبًا، وأسواق الأسهم تضرَّرت بعُمقٍ، وتداعيات الحرب الجمركية تمور تحت السطح، وسرعان ما ستنعكس على منحنيات البطالة والتضخُّم فى بيانات الشهور المُقبلة.
والأخطرُ؛ أنَّ الصورة تهتزّ، ورمزية السردية المُتفوِّقة أخلاقيًّا ومَعرفيًّا تتآكلُ بوتيرةٍ مُتسارعة. الجامعات على هزّازٍ يتوسط جسرًا ضيِّقًا بين الإخصاء وأن تكون بيئةً طاردة، والتوحُّش فى ملفِّ الهجرة يُهدِّدُ الخزّان البشرىَّ، ويُربِكُ مُجتمعًا اعتادَ أن يُجدِّد عافيته وشبابه من دماء الآخرين وعطايا أرحامهم.
الحروبُ لا تتوقَّف، والعضلات التى تُخيف مرّةً؛ إمَّا أنْ تبطش بغريمها، أو تُضحِّى بفاعلية الردع، وتُشجِّع الحانقين على أن يتجرّأوا ويُجاهروا بالرفض والاعتراض.
يلعبُ الرئيس العظيم بالعالم؛ أو هكذا يتوهَّم، وفى الواقع فإنه يمضى ببطءٍ وانعدام وزنٍ لجهة أن يكون ألعوبةً فى أيادى الأصدقاء والأعداء على السواء. كان قد ادَّعى أنَّ الحرب الأوكرانية خطيئةُ بايدن الكاملة، وأنه قادرٌ على إنهائها فى نهارٍ وليلة، وقبل أن يتسنّم مقعد الحُكم أصلاً.
مائةُ يومٍ وما تزال الحرب دائرةً، والدبُّ الماكر فلاديمير بوتين يُراقصه على الحبال، ويفوقُه رشاقةً واقتدارًا على المناورة.
وكان قد ادَّعى أيضًا أن عملية طوفان الأقصى واشتباك حماس مع إسرائيل ما كان لها أن تقع لو كان فى السلطة، وبإمكانه أن يُغلق دفترها قبل أن يُضيف إليه المُتصارعون حرفًا أو كلمة. أرغى وأزبدَ وهدَّد قبل موعد التنصيب، واحتواه الحماسيِّون والصهاينة باتِّفاقٍ للهدنة، نقضَه نتنياهو بعد مرحلةٍ واحدة ضمن مراحل ثلاث، وما يزال ضبع الليكود يتفوَّق على راعى البقر المُترهِّل، أو بالأحرى يُمرِّرُ رؤاه من فوق رأسه الكبير جدًّا، والمُمتلئ علمًا وحكمةً وإبداعًا وتفوُّقًا على كلِّ البشر من دون استثناء.
غادر اتفاق أوباما النووىّ مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ لأنه سيِّئ، مُختلّ، ويُكافئ الشقىَّ بدلاً من عقابه على قفز الأسوار العالية. واليومَ؛ يعودُ إلى العاصمة العُمانية ليتفاوض على البنود ذاتها مع طهران، بفارقِ أنه يُلاقيها وقد أثخنتها الطعنات، وقُلّمت أظفارُها على امتداد الإقليم. تصلحُ الآن أنْ تُتّخَذَ منصَّةً للاستعراض والبطولات الرخيصة؛ لكنَّ تجَّار البازار ونسّاجى السجاجيد المُحترفين يمتازون بالصبر والأناة، ويُحسنون الفصال وتقطيع الوقت.
يعرفون أنه سيقبل بما كان يرفضه، أو يعود للجمود دون مُقامرة بالحرب. والرجلُ يُطوِّقهم بالقاذفات والبوارج، ويُحاورهم بمبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، شريكه وسَمِيّه فى تجارة العقار، وآتٍ مثله من خارج فضاء السياسة وأناقتها المُبالغ فيها.
يُرسلُه لموسكو على فواصل مُتقاربة، وبينها إمَّا على طاولة الشيعيَّة المُسلَّحة، أو فى مُداولات غزَّة الجريحة، ولا أثر مُطلقًا لوزير خارجيته ماركو روبيو، المُشرّع السابق، والوحيد فى الإدارة كلِّها الذى قد يكون جديرًا بمنصبه، ولم يكن محلَّ خلافٍ بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال جولات التثبيت فى الكابيتول.
ليس تفصيلاً عابرًا على الإطلاق. الرجل الذى يجلس على قُبَّةٍ تحتوى تحتها أعقدَ شبكةٍ من المُؤسَّسات والأعراف النظامية المُنضبطة فى العالم، لا يكتفى بالخروج من صحن الدولة إلى العراء؛ بل يُمارس لعبة النفى والاستبعاد داخل العائلة الواحدة، ويُعيد تعريف المناصب والمسؤوليات، ويختزل الأمورَ كلَّها فى شخصه.
ربما لا يثق فى روبيو فيُجنّبه؛ لكنَّ الأرجح أنه يَعُدُّ نفسَه وزيرَ الخارجية الأمريكية، ويُفوِّضُ مبعوثَه وَظلَّه الخاص فى المهام الروتينية السيَّارة. الجميع لأجل الفرد، وتلك وَصْفةُ الشمولية ولو طُبِخَت فى المكتب البيضاوى، أو تحت ظلال تمثال الحرية.
مائةُ يومٍ وما أحدث الرئيسُ شيئًا ملموسًا، أثار غبارًا على مَدَد الشوف، والجعجعة لا تنقطع؛ إنما من دون طحنٍ. يُؤسِّسُ أسطورته بحسابات البيزنس، ويعكفُ على سرديَّة المُفاوض وصانع الصفقات.
صارت التقنية مكشوفةً للغاية؛ إذ يُهدِّد بإصابة الرأس، بينما يُصوِّب على الأقدام، وغايته أن يُصَعِّد المزاد؛ ليرتضى الخصوم بالخسارة المُخفَّفة، أو بها كاملةً بغلافٍ مُختلفٍ وتسميةٍ مُحسّنة.
يطبعُ بصمتَه الثقيلة على وجه الولايات المُتّحدة، وبعيدًا من أطماعه فى العبور إلى ولايةٍ ثالثة؛ فالجوهر المُرَاد اقتناصه أن تُواصل الترامبيَّةُ مسارها؛ ولو تعثّر ترامب فى منتصف الطريق.
ما يزالُ مُغرمًا بالجُمل المُنتفخة واصطناع الصدمات. يجدُ نفسَه الضائعة كلَّما أربك الآخرين، ويتحقَّقُ بالحنجرة قبل اليد أو العقل. الصمت لا يزيده إلا شراهةً، واحتمال الصفعة الأُولى وتمريرها؛ سيستدعيان بالضرورة مزيدًا منها.
يكبحُه الخطأ ولا يُعلّمه للأسف، وتصدُقُ فيه عبارةُ تشرشل الشهيرة بأكثر مِمَّا تصدُق على أىٍّ من أسلافه؛ إذ هو التجسيد الأوقع لحقيقة أنَّ «الولايات المُتّحدة تتّخذ الموقفَ الصحيح؛ إنما بعدما تُجرّب كلَّ الطرق الخاطئة».
قبل يومين، استقبل الانتخابات الكندية بتجديد الحديث عن استلحاقها لتكون الولاية الحادية والخمسين. لم يتوقّف عن الرسالة المُملَّلة بنصِّها منذ اقتناصه تذكرة العودة إلى البيت الأبيض، ولا يسترعيه رفضُ الكنديين، أو صعوبة ابتلاع بلدٍ يفوقه حجمًا، ولا القِيَم التى يُسرِّبها للآخرين، خصومًا وحُلفاء، من وراء الاستخفاف بالقانون، وإزهاق حُرمة الدول والحدود.
والأمرُ يتكرَّر مع جرينلاند، وفى صفقته العجيبة عن «ريفييرا الشرق» المُبشَّر بها فى قطاع غزَّة، واللَجَج الذى لا ينقطعُ عن قناة بنما والسيطرة عليها، وصولاً إلى حديثه عن العبور من الممرَّات المائية الحيوية فى الغرب والشرق مجانًا.
مُحصِّلُ ديونٍ قديمة ومعدومة تقريبًا؛ والديّانةُ لسانُ حالهم: إن لم نجدها لاخترعناها؛ ولو من عَدَمٍ وتلفيق. تشعرُ أنه أفلس؛ فاتّجه للتفتيش فى دفاتره الصفراء. أجدادُنا حفروا قناة بنما فلتكُن لنا، ومَوّلنا أوكرانيا فى حربها الأخيرة فلنُسيطر على مواردها الطبيعية، والاقتصاد الحُرّ الذى دَعَونا إليه وتربّحنا منه أفاد المنافسين؛ فلنقتسم معهم أرباحهم المشروعة والمُحصّلة بالجهد والعرق.
وماذا عن النطاقات التى لا أدوارَ لنا فيها، أو العناوين التى تجسّدت قبل أن نتجسّد ونصبح دولةً أصلاً؟! هُنا قد تسدّ البلطجةُ ثغرةَ المنطقة، أو تتكفّل ألاعيبُ الحُواة و«الثلاث ورقات» بالإرباك وخلط الأوراق.
مائةُ يومٍ كأنها قرنٌ كاملٌ، وكأنها لا شىء أيضًا. تلالٌ من الأخبار ورُكام التصريحات؛ حتى صار الرجل شريكًا بالمُناصفة فى الوسائل الإعلامية، وحاضرًا على كلِّ لسانٍ خارجها، والمُحصّلة صفر كبير.
تتفسّخُ الولايات المُتّحدة من داخلها؛ لجهةِ الثقة والمناعة الذاتية على الأقل. يتحسّب العوام فيها للحاضر، ويتخوّف العقلاء على المستقبل. الرئيس ماضٍ نحو صياغة أسطورته كما يراها، ولا يُشرِكُ حبيبًا أو غريبًا فى اقتراح الخطوط الدرامية، أو ضبط الحَبكة، واستشراف مُقدّمات العُقدة ومسارات تفكيكها.
العالم يتحلّل من ردائه القديم، ولا يتّفق على طبيعة المرحلة وملابسها، ويبدو أنه قد يُضطرّ للسير عاريًا فى عراءٍ لا حدَّ له ولا سقف يُداريه. ستكونُ الولاية اثنتى عشرة نسخة من أيامها المائة الافتتاحية، يخرجُ من حُفرةٍ لِمَا بعدها، وتتغيَّر المواقفُ والأبطال ولا تتبدّلُ الأحداث والمآلات، وندورُ جميعًا فيها كدوّامةٍ مُغلقة، أو ننتقل من غرفةٍ لأُخرى كأنها متاهة. الامبراطور نفسُه تفتنُه شخصيّة القرصان، والمُعضلة أنه لا يُجيد أيًّا من الدورين. وأنه لا يُريدُ الإبحار الآمن، ولا يعرفُ طريقَ الخروج إلى الشاطئ للأسف.
Trending Plus



 فيسبوك
فيسبوك
 واتساب
واتساب