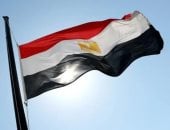وكأنّ غزة المنكوبة لم تشبع موتًا.. عن قابيل وقبائلية الفصائل ونزق الاستخفاف بالدم

ليس القتلُ من وظائف الإنسان الأصليّة، ولا لهذا خُلِقَ من الأساس. اخترعه قابيلُ وجرّعه لأخيه طمعًا فى امرأته، على ما يَرِدُ فى الأثر القديم. أى أنَّ المنشأ لم يكُن عن ضرورةٍ أو احتياج مُلِحّ، كأن يدفعَ الشخصُ ضررًا أو يستنقِذَ نفسَه من مَهلَكة.
وبعدما اتّسعت العائلةُ البشرية وانقسمت على نفسِها، صُبِغَ بُمبرِّراتٍ شتّى، لكنّه ظلَّ يُعبِّر عن الحالة البدائية الخَشِنة، وينشأ من ضعفٍ لا من قوّة.
تتعطّلُ مَلكَة العقلِ فتنشط العضلات، ويخرجُ المَرء من لباس جنسِه ليدخُل فى هياكل الجوارح، ويُقرِّر مُستسهِلاً أن يحسمَ المُنازعات بالشَّطب، لا بالحوار والجدل، والاحتكام لقواعد وقوانين مُجرّدة ومُحايدة تجاه الجميع.
ربما لم يعُد التاريخُ الغابرُ صالحًا للتفسير، لكنه مادّةٌ دائمةٌ للفهم، ومَدخَلٌ وُجوبىٌّ لاستكشاف الظواهر وتتبُّع مسارها وصيرورتها. زاد الطَّلَب أو تقلَّص العرض، الخُلاصة أنَّ عددًا أكبر صاروا يختصمون فى موارد أقل. وبدلاً من التكاتُف والعمل المشترك لزيادة القليل، انصرفت الجهودُ إلى الاشتباك والتناحُر لإنقاص الكثير.
الحروبُ وسيلةٌ لاستعراض السطوة وتحقيق الغَلَبة، لكنها تتأسَّس فى المقام الأوَّل على الهَدر من الخزَّان البشرى، والإرعاب و«كَىِّ الوعى» بفائضٍ من التوحُّش وإبراز المآلات القاسية. والساقيةُ دوَّارة، وسافكو الدم لا يَرتوون، والوجود فى معركةٍ أبديَّةٍ مع العدم والإفناء.
انتفخ بنيان قابيل ليصير قبيلة، وتضخَّمت هى حتى تشكّلت على صورة الدولة. المرأةُ صارت أرضًا أو ثروات، والموت واحد فى الحالين. إزاحة هَيّنة بين موضوعات النزاع. تبدَّلت معالم الدراما وما تغيّر جوهر الشر وبواعثه، وبات من الرومانسية المحضة أن تتحدَّث عن عائلةٍ إنسانيّة واحدة، أو أن تهجو الحيوانية التى كانت تتراقص على نصال السيوف، وصارت تتكدَّس فى عُلَب القنابل وفوّهات البنادق والدبابات.
ولو أنَّ القاتل الأول بترَ ذراعَه بعدما تخضَّبت بدم شقيقه، لكانَ البشرُ جميعًا الْتَمَسوا طريقةً اعتذارية مُبكِّرة لاستشعار الندم، وللاعتدال والتصويب. أمَّا الغريب فأنْ ترى هابيل يقبضُ على سِكِّين ظالمه، ويطعن قلبَه بيدِه، بينما يلفظُ أنفاسَه الأخيرة. هنا تكونُ المُسالمة المُفرطة عدوانًا فى واقع الأمر، وإسنادًا للمُعتدى، وقتلاً أفدح من القتل الأصلىِّ.
لا يخلو يومٌ فى دفتر النكبة الغزِّية من أخبار هابيل المازوخىِّ. صار التنكيلُ بالذات عنوانًا ثابتًا، ومُتكرِّرًا دون انقطاعٍ أو مَلَل. الأسبوعُ الأخير وحده شهد ما يُقارب عشرَ حالات إعدام ميدانيَّة، بحسب المشاهدات المنقولة عن عوامّ ومُراسلين صحفيين.
تتوزّع الأسبابُ على التخوين والاتهام بالعمالة أو السرقة، والفاعلون بين حماس وحُلفائها من الحركات المُسلّحة. وإذ يفرُّ الناس من نار الصهاينة، فإنهما ليسوا فى مأمَنٍ على ما يبدو من نيران المقاومة، كما لو أنهم بين شِقّى رَحَى، أو يستجيرون من الرمضاء بالنار.
حُرمةُ الدم ليست ثابتًا أصيلاً لدى الأُصوليّة وتيّاراتها، وفى كل تاريخها. تجزمُ بها النصوص، وتخترقها المُمارسات بتلفيقٍ فجٍّ واحتيالات شتّى. ذخيرةٌ فِقهيّة عظيمةٌ تُبرّر التترُّس، وتُؤاخى بين المُعارضة السياسية والارتداد الدينى، وتراثٌ حَرَكىٌّ يحتكر الطهرانية، ويختزل فسطاط الإيمان فى لونٍ واحد تحت رايةٍ بعَينها. ما يعنى أنَّ المُقاومة قد تنزلِقُ بخِفّةٍ إلى ما يأتيه الاحتلال، وإن اختلفت الرُّؤى وتضادّت البواعث والمُحفّزات.
كلاهما يرفعُ عناوين برّاقةً، وخادعةً لحاضنته ومُشايعيه، من النضال لحقِّ الدفاع عن النفس، ومن فريضة إرهاب العدو إلى فضيلة مكافحة الإرهاب، والهُمَّل المنكوبون ضحايا للطرفين فى كلِّ الأحوال.
اصطُنِعَت الحربُ الأخيرةُ وفقَ حسابات «فوق فلسطينية». بالأولوية أو الاستطاعة، وبما يُمكِنُ أن يُبنَى عليها أو يُستَفَاد منها فى تثميره سياسيًّا. وقفَ الراحل يحيى السنوار «أبو إبراهيم» وراء الطوفان تنظيرًا وتطبيقًا، وارتكز فى مُعادلته على إغراء الضربة الافتتاحية، وما دون ذلك أو فوقه لم يكُن يعنيه فى شىءٍ تقريبًا.
العدوُّ قاتلٌ بالفطرة، يلغ فى الدم ويلوك الأكباد، لذا ما كان مُتوقَّعًا من الصفعة إلَّا أن ترتدّ بنازلةٍ ثقيلة، سواء أراد المُخطِّط هذا، لتأليب المنطقة وخَلط أوراقها، أم وُرِّطَ فيه بإملاءٍ غشومٍ أو بعشوائيّةٍ ومَظّنة بأس، فالمُحصّلة أنه فتحَ «صندوق باندورا» وفرّغ محتوياته على رؤوس العُزّل، واستجلب لهم الموت مخلوطًا بالفقد والجوع والخراب العميم.
بُنِيَت أسطورةُ قائد حماس الراحل على القنص من داخل الحظيرة. عُرِفَ أوّلَ ما عُرِف بتأسيسه جهاز الأمن والدعوة «مجد» وقيادته، بدءًا من منتصف الثمانينيات، وكانت مهمّته محصورةً فى اصطياد «العملاء» وتصفيتهم، هكذا من دون فحصٍ أو تمحيصٍ ومُحاكماتٍ طويلة ومُرهِقة.
والمفارقة، أنه قضى أغلبَ سنواته فى سجون الاحتلال عن دماء أربعةٍ من الفلسطينيين، فكأنَّ العدو القاتل يختصمُه فى ضحاياه، أو يلومُه على أنه اقتطع لنفسِه من الفرائس الموقوفة عليه حصرًا. كلاهما قتَلَ وتاجَرَ بالقَتلى للأسف.
وفى زمن الانقلاب العظيم، وقد عدّته الحركةُ فَتحًا ربّانيًّا مُبينًا، مثلما اعتبرت شقيقتُها العزيزة، ميليشيا حزب الله اللبنانية، أنَّ اقتحام العاصمة بيروت وتصفية زهاء 60 مدنيًّا بريئًا من طينة الفتوح والإغارات الإيمانية المقدّسة.
أُلقِىَ الفتحاويّون وغيرُهم من أعالى البنايات، وسُحِلَ آخرون وراء سيَّارات القسّام فى شوارع القطاع. وما كان يُقالُ عن الخَوَنة تحت أيدى السنوار وجهاز مجد، لم يَكُن مُتاحًا مع مُمثّلى السلطة وأعضاء أقدم حركات المُقاومة وأبرزها، وأكثرها خوضًا للمُغامرات وسدادًا للأثمان الباهظة. هكذا قُفِزَ على المَقتلة دون حاجةٍ للتبرير أصلاً، ولم يجهدوا بأية درجة فى اختلاق الأعذار، أو تمرير الجريمة بقَدرٍ من التحفُّظ والأسى والاهتمام.
والحال، أنَّ حماس مُختَرَقةٌ حتى النخاع منذ نشأتها. قُتِلَ عناصرُها فى الأردن ودمشق وضاحية بيروت الجنوبية، ونُحِرَ أرفعُ قادتها فى أحضان المُرشد الأعلى بالعاصمة طهران. خالد مشعل كان ضحيّةً لمُحاولة اغتيالٍ شديدة السهولة فى عمّان أواخر التسعينيَّات، ولولا موقف الملك حسين لقضى من يومها وأُغلِقت صحيفته. والقائمةُ مُمتدَّةٌ إلى أحمد ياسين والرنتيسى والمقادمة والمبحوح وصلاح شحادة وغيرهم.
توغَّل الموساد عميقًا فى المفاصل، وتمَوضَع فى قلب الحركة وداخل مرافقها، وصولاً إلى صَفِّها الأوّل كاملاً فى الحرب الأخيرة، ومنذ ابتدائها، وقبل أن تطرأ أحداثٌ تُغيّر مشاعرَ الغزّيين أو تُثير حنقهم على الفصائل.
وما من مُبرِّرٍ إطلاقًا لاختصام الجمهور وتوفير الحركيِّين. إذ الأقربُ للمَنطق أنَّ قادةً رَفيعِى المستوى، مثل الضيف ومروان عيسى ورافع سلامة، لم يكونوا فى مجال نظر العامّة أصلاً، وأغلب الظنِّ أنهم لو سُلِّموا بخيانة، فإنها من داخل البيت، وعلى أيدى قسّاميّين مُطهّرين، أو آخرين من الأُسَر الحماسيّة المُباركة.
تَخَلخَل البناءُ واهتزّت دعائمُه، وما عاد مأمونًا أن تجزِمَ بالخيانة وتُرجّحَها على فكرة الهشاشة والانكشاف، ونفاذ آلة المعلومات الإسرائيلية إلى الأعماق بعملٍ ميدانىٍّ على الأرض، أو بطائراتها الزنّانة فوق الرؤوس والأنفاق.
وحتى مع احتمال التغرير بالبعض، والاستحصال منهم على معلوماتٍ ماسّة بالحركة وقُدراتها المُتداعية، فتَغليبُ حُسنِ الظنِّ يجبُ أن ينصرفَ إلى سوء الأوضاع الراهنة أوّلاً، وإلى الموت المُطوّق للجميع من كلِّ الجهات، والجوع الكاتم على الصدور والأرواح. وكلُّها تفاصيل موجِعةٌ لم يتسبّب فيها الغزّيون، ولا اتّخذوا قراراها أو استُشيروا فيه.
وبدلا من الاعتذار لهم عن الحال البائسة، وعن وضعهم فى مجالٍ خانق ومنزوع الخيارات، يُلامُون على أنهم لا يتعبّدون للميليشيا بإيمانٍ زاهدٍ مُنسَحِق تمامًا، وأنهم يصخبون فى المأساة، أو يستنكفون أن يكونوا قرابينَ مجّانيةً على مذبح الأيديولوجيا والمصالح الفئويَّة الضيِّقة.
أوردت بعضُ المنصّات الإخبارية، عن مصادر من حماس وبعض فصائل المُقاومة، أنَّ السلوك الحاسم اليومَ يأتى تحت الحالة الثورية، والعقوبات تتنوّع بين الإعدام، حال الإبلاغ عن المُقاتلين أو التسبُّب فى الإيقاع بهم، أو التعويق برصاصةٍ على القدم أو بالضرب المُبرّح، فى حالات السرقة والترويع.
والخلاف ليس على تجريم الجريمة، ولا الفصال فى الجزاء، بل على أحقيّة القاضى بأن يجلس إلى المنصّة، ويُنصِّبَ نفسَه حَكَمًا على الآخرين، وقضاءً مُبرمًا دون ادِّعاءٍ أو دفاع، وبتعجُّلٍ يتعذَّر الاستيثاقُ من صفائه وموضوعيَّته، ويستحيلُ الرجوع عنه حالما يتبدّى العكسُ، أو تنتفى الإدانةُ للمُتَّهم البرىء حُكْمًا حتى تثبُتَ إدانتُه.
البدايةُ خاطئةٌ، ومُحرّفةٌ ومُنحرِفة. تنطلقُ حماس من كونِها مرجعيّةً وقانونًا، وتضعُ الجميع على لائحة الشكِّ ابتداء، ثم تُمضِى عليهم أدواتها بانفراديّةٍ كاملة، ومن دون مُحاكمةٍ أصلاً، ناهيك عن درجات التقاضى.
والخلل إنما ينبُع من توصيف الواقعة الواحدة على صُوَرٍ مُتضادّةٍ ومُتضاربة، إذ يُؤخَذ المشكوكُ فى إبلاغه عن مُقاتلى القسَّام مَثلاً بجريرة الخيانة، لأنهم تسبّبوا فى تمكين الصهاينة المُحتلِّين من بعض الغزّيين الأبرياء، وفى المُقابل لا يُنظَرُ للطوفان، وما جناه السنوار وعصابته، على أنه كان تمكينًا شبيهًا، وأكثر فداحةً وشمولاً، وأوقَعَ أضعافَ الضحايا والخسائر المُحتمَلة عن أيَّة عملية استخبارية.
أمَّا الفارق الأبرز بينهما، فأنَّ الأخيرة ثابتةٌ قطعًا، بالقرينة والدليل والمُشاهدة، بينما الأُولى فى نطاق الظن، ولم تَستوفِ اشتراطات الموثوقيَّة والإثبات على أىِّ وجهٍ مكتملٍ أو منقوص، وصحيح أو مُعتلّ.
تنقطعُ صِلات الأجنحة القسّاميّة ببعضها، وتتعطّل الاتّصالات والقدرات العَمليّة، ويقول المُتحدّث المُلثّم كثيرًا إنهم ضيّعوا بعض الأسرى أو لا يعرفون أماكنهم وحالاتهم. الحركة هشّة ومُتداعية، ومرافقها مُعطّلة أو مُجبَرة على الاختباء. ولا يُعرَف كيف تتأتّى لهم المعرفة العميقة بالعملاء، والوثوق فى معلوماتهم تلك، وإقامة الحجّة بها على المُتّهمين وحسابهم بشكلٍ مُعَجَّل.
والمأخَذُ من أيسر الطُّرق، أنَّ القطاع لم يَعُد بيئةً طبيعيَّة على الإطلاق. لا فى معاش الناس وسلوكه، ولا فى الضغط الواقع عليهم من الداخل والخارج. وفى سياقٍ كهذا، لا يُمكن أنْ يُؤخَذ الفردُ بمحاذير الأحوال العادية وقوانينها، ولا أن يُطمَأنَّ من الأساس لإمكانيّة القيام على عمليّةٍ أمنيّة دقيقةٍ بمنطقٍ واعتدالٍ ومعرفةٍ مُعمّقة.
ثارت ثائرةُ الغزِّيين ضد حماس قبل أسابيع، وتتابَعَت تظاهراتُ الغضب وهتافاتُ الاستهجان والتعريض. الغالبيّةُ لا يُقرّون الحركةَ على سُلوكها اليومَ، ولا ما كان لعقدين فائتين، وإذ مُنِعوا من التصريح تحت سطوة السلاح، فإنهم الآن أقدرُ على المُجاهرة. والحركةُ تنظُر وتحسِبُ وتختزن، ولا تغفرُ لخصومها كما جرَتْ العادة.
وما أدرانا أنَّ الموصومين بالعمالة راهنًا، كمُقدّمةٍ للقصاص منهم برصاصة فى الرأس أو على أعواد المشانق، ليسوا من الغاضبين الذين مسّوا بالمقام الحماسىّ المُطهّر. فضلاً على أنَّ بعض عناصر التنظيم وأجهزته الأمنية تورّطوا فى صداماتٍ مُباشرة مع الأهالى، ومنهم من قتلَ أفرادًا فى صراعاتٍ حوالىّ مخازن المُؤن وداخلها.
وكلُّها أماراتٌ على تعقُّد العلاقات واختلال المُعاملات، ونشوء خصوماتٍ مُباشرة بين الشارع والفصائل، عمومًا أو فى فردانيّتها المُمثَّلة بالأعضاء والمُنخرطين تنظيميًّا، وبعضهم ليسوا فوق الشبهات، ولا يخلو الأمر من تعريضٍ أو تصفيةٍ للحسابات الشخصيّة أحيانًا.
وإذا بُرِّرَ البطشُ الحالُّ بالضرورة والامتحان الوجودى، على سخف التبرير ووقاحته، فإنَّ وقائع الانقلاب سابقًا لم تكُن تحت السقف ذاته، وإسناد الإخوان ضدَّ مصر فى أجواء الربيع العربى أيضًا. والبلاغةُ والمُواءمات السياسية والدعائيَّة لن تُغيّر حقيقةَ أنَّ حماس تنظيمٌ مُغلق، تنظر لكيانيّتها على أنها الفئةُ المُؤمنة بين فئاتٍ ضالّة، ثمَّ تختزل القضية فى القبائلية، فيصير الآخرون خصومًا للحق والعدل، لا لعنوانٍ أيديولوجىٍّ أو لافتةٍ فصائلية.
وبهذا، تُحرَّف المُقاومةُ عن مجالها الموضوعى، بوصفِها عملاً وطنيًّا نضاليًّا نبيلاً، إلى مسلك ميليشاوى مافيوى يضعُ نفسَه فوق بيئته، ويُرتِّب مصالحَه بمعزلٍ عنها، ولا يُفرّق بين قتال العدو وقتل الصديق، إذ تتحدّدُ العداوة والصداقة بمقدار الانخراط فى مشروعٍ واحد، وليس بالشراكة فى الأصل والهَمّ والمُنطلقات والأهداف.
وإذا كان الإرهابُ مقبولاً فى نضالات التحرُّر، أقلّه على معنى «تُرهبون به عدوَّ الله وعدوّكم»، فإنه حالما يُوجّه بنادقه إلى صدورِ المنكوبين والضحايا، يصيرُ مشروعًا خصاميًّا مع الحق، ولو ادّعى العكس وتاجر به لأغراض التقيّة والتخفّى. ومن هُنا، يصعُب النظر للطوفان خارج النفعيّة الميليشاوية لا الدفاع عن القضية، لأنه لم يضع الأخيرة فى اعتباره بعد الرصاصة، ثمّ لم يتورّع عن التنكيل بأهلها لاحقًا تحت مزاعم وادّعاءات شتّى.
ولا يُمكن من أىِّ وجهٍ أن يُنتَقَد القتيلُ على صرخة الوداع، ولا أن يُلام الجائعُ لأنه خرج يسرق رغيفًا أو يحتال عليه. حتى وصول العدوِّ إلى بعضهم بالخديعة والمَكر، يُحمَلُ على خطايا الحماسيِّين لا دناوة المُتعاونين أو انتهازيّة الغزّيين.
لقد عاشوا سنواتٍ سوداءَ تحت حُكم الحركة، واحتملوا سخفَها ومُزايداتها، وسُرِقَتْ أحلامُهم ومُمتلكاتها، وحتى مساعدات الأغراب يرونها تتدفّق على الأنفاق أو الأسواق، وفى الجَردة الأخيرة يُقرّر المُقاتلُ القسّامى أن يُشهِرَ سيفَه على الجميع، ويستعير حاكميّة الله وقضاءه بدلاً من أن يعتذر لضحاياه عمَّا حاق بهم.
ليس من صالح القطاع أن يستنسخ وحشيّة قابيل تحت راية القبائليَّة الأُصوليَّة. ولا يخدمُ فلسطينَ أن يُقَسَّم المُقسَّمُ أصلاً، وأن يتمادى المُخطئ فى خطاياه دون ندمٍ أو اعتذار. الإعداماتُ تتعالى على الواقع، وتدعس العدالةَ بالحذاء، وتُوسِّعُ الإِحَن والشروخ النفسية بما قد تستحيل مُداواته لاحقًا.
ولا يصحّ أن تستبدّ الفصائلُ بالأرض والبشر، ثمَّ تُحاسبهم على أفعالها الذاتيّة الخالصة، وتمنعهم من الشكوى والتعبير عن الألم. ومن السخيف أن يتعطّل السلاحُ فى مُواجهة الأعداء، بينما ما يزال فاعلاً فى رقاب الأشقاء، كأنَّ غزّة لم تشبع موتًا، وكأنَّ شهوة القتل استبدّت بالمُناضلين فحوّلتهم وحوشًا، يصطادون من القطيع ويستأسدون على الهزيل منها والضعيف.. ثمّة جرائم عِدّة فى صحائف الفصائل، أفدحها الولوغ فى دماء الغزّيين، وأسوأ ما تَنُمّ عنه تقريب المُختلّ للمُحتلِّ، اعتقادًا وسلوكًا وأثرًا، ثمّ تذويب الفارق الباهت بين القاتل والمُناضل، حتى ليَتَساوى الاثنان للأسف فى عَينَى القتيل.
Trending Plus



 فيسبوك
فيسبوك
 واتساب
واتساب