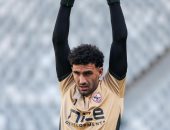كواليس الإدارة الأمريكية وسياسة مصر في معادلة الصراع العالمي

في كواليس السياسة العالمية، تتبدل الأدوار وتتغير الوجوه، لكن اللاعب الحقيقي لا يغادر المشهد أبدًا. في الولايات المتحدة، حيث تُملى السياسات الكبرى من وراء الستار، لم يكن صعود دونالد ترامب مرةً أخرى إلى واجهة المشهد السياسي محض مصادفة، بل تحركًا محسوبًا من دوائر النفوذ، وعلى رأسها شركات السلاح العملاقة.
رغم الخطاب الانتخابي الهادئ الذي قدّمه ترامب، والذي وعد فيه بإنهاء الحروب ووقف نزيف الدم في أوكرانيا وغزة، فإن واقع التمويلات السياسية يعكس وجهًا آخر. شركات مثل لوكهيد مارتن، بوينغ، رايثيون، ونورثروب غرومان، ضخت عشرات الآلاف من الدولارات في حملته الانتخابية، أرقام تبدو محدودة بسبب القيود القانونية، لكنها تمثل رأس جبل الجليد. الجزء الأكبر من التمويل جرى عبر جماعات الضغط ومؤسسات سياسية تلعب في الظل، ممولة بملايين الدولارات لتوجيه السياسات حسب مصالح المجمع الصناعي العسكري.
ترامب لم يخذل داعميه؛ فميزانية الدفاع الأميركي في عهده وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتجاوزت حاجز التريليون دولار في موازنة الأمن القومي الجديدة. تشمل هذه الميزانية تحديث الترسانة النووية، تطوير مشاريع الدرع الصاروخي، رفع أجور العسكريين، وتعزيز ميزانيات الأجهزة الأمنية. سياسة تسليحية تُعيد للأذهان نهج رونالد ريغان في الثمانينيات، لكنها تُترجم اليوم في عالم أكثر هشاشة واضطرابًا.
هذه التحولات في واشنطن تكشف أن القرار في أمريكا لم يكن يومًا بيد رئيس منتخب، بل نتاج مصالح كبرى تُدار بدقة متناهية. والمشهد نفسه يتكرر بأشكال مختلفة في عواصم أخرى، وسط سباق نحو السيطرة وتثبيت النفوذ.
في قلب هذا الإعصار الجيوسياسي، تتحرك مصر برؤية استراتيجية مختلفة. دولة تعلم من التاريخ، وتستقرئ الحاضر بدقة، وتسعى لتأمين المستقبل من خلال امتلاك عناصر القوة الشاملة. فخلال العقد الماضي، لم يكن تطوير الجيش المصري خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وجودية فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية. المعدات الحديثة، التدريب المتقدم، وعقيدة القتال المتجددة، كلها عناصر عززت من مكانة الجيش المصري كقوة ردع لا يُستهان بها.
الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّر عن هذه الفلسفة مرارًا حين أكد أن "من لا يملك جيشًا وطنيًا وسلاحًا عصريًا، لا أمان له". لم تكن هذه الكلمات شعارًا، بل قاعدة تحكم مسار الدولة المصرية في التعامل مع محيطها. وفي منطقة تحولت إلى ساحة لتجريب الفوضى، حيث انهارت الجيوش وتفككت الدول، بقيت مصر متمسكة ببنيتها الوطنية، مقاومة لكل محاولات الإضعاف والتفكيك.
المحاولات التي سعت لإعادة تشكيل العقيدة العسكرية المصرية عبر حصرها في مكافحة الإرهاب فقط، كانت تهدف إلى صرف النظر عن التهديدات الكبرى، سواء تلك المتعلقة بالجغرافيا أو الأمن القومي أو الموارد الاستراتيجية. لكن مصر قرأت المشهد بوعي، وتبنت سياسة قائمة على "الصبر الاستراتيجي"؛ التريث المدروس مع الاستعداد الدائم، دون الانجرار إلى ردود أفعال ارتجالية.
القراءة المصرية للأمن القومي لا تنفصل عن الاقتصاد، والإعلام، والوعي الجمعي. فمواجهة التهديدات لا تكون بالسلاح وحده، بل بإدراك حجم المعركة النفسية، ومحاولات هدم الثقة بين المواطن والدولة، وتقويض أركان المؤسسات. وما شهدته دول مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان، لم يكن سوى نموذج واضح للاستراتيجية التي تستهدف تفكيك الدول من الداخل، وتحويلها إلى مساحات رخوة تسيطر عليها الميليشيات والتنظيمات غير النظامية.
ومع تصاعد الصراع العالمي بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة، تزداد أهمية الشرق الأوسط كمنصة لتشكيل النظام العالمي الجديد. فالفوضى التي اجتاحت المنطقة منذ سقوط بغداد لم تكن عشوائية، بل جزء من مشروع ممنهج لهدم الدول المركزية، ومنع قيام أنظمة وطنية قوية قادرة على اتخاذ قرار مستقل.
مصر، بوعيها التاريخي وموقعها الجغرافي، تدرك جيدًا أن الحفاظ على السيادة له ثمن باهظ، وأن امتلاك القرار السياسي يتطلب بنية أمنية واقتصادية متماسكة. لذلك، فإن استراتيجيتها لا تتوقف عند بناء الجيوش، بل تمتد إلى امتلاك أدوات التأثير الناعم، والقدرة على إدارة الأزمات، واحتواء الصدمات.
التهديدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، ومنها سيناريوهات التهجير وإعادة رسم الخرائط، وضعت مصر في اختبار جديد. لكنها أثبتت أن أمنها القومي لا يقبل المساومة، وأنها قادرة على فرض رؤيتها، وحماية حدودها، دون التخلي عن دعمها التاريخي للشعب الفلسطيني.
في النهاية، ما تقوم به الدولة المصرية اليوم ليس مجرد رد فعل، بل مشروع متكامل لبناء قوة شاملة، تستند إلى فهم عميق لطبيعة المرحلة، وتوازنات القوة، وتحولات الإقليم. في عالم يعيد تشكيل نفسه، تُصر مصر على أن تكون طرفًا فاعلًا، لا تابعًا، ورقمًا صعبًا في معادلة لم تُكتب نهايتها بعد.
Trending Plus



 فيسبوك
فيسبوك
 واتساب
واتساب