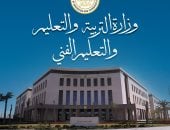من الداخل تبدأ الخريطة.. أوروبا ونظرية الشراكة الإقليمية

مما لا شك فيه أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة البريطانية لندن، تحظى بخصوصية كبيرة، ليس فقط في إطار كونها أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى بريطانيا منذ سنوات، أو حتى بالنظر إلى الإرث التنافسي الذي يهيمن على شكل العلاقة بين البلدين، منذ الحقبة الاستعمارية، وإنما في إطار توقيتها، حيث تتزامن مع محاولات القارة العجوز إلى تعزيز دورها في عالم يبدو في طور التشكيل، وهو ما يبدو في شكل الصراعات المهيمنة، والتي تتسم بطبيعتها الممتدة زمنيا والمتمددة جغرافيا، حتى طالت حدودها، منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد عقود طويلة من الاستقرار النسبي، ناهيك عن التغيير الملموس في العلاقة مع واشنطن جراء مواقفها، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، أو حتى فيما يتعلق بشكل العلاقة مع الحلفاء، والتي باتت تقوم في الأساس على التحول من حالة الشراكة، وإن كانت شكلية، إلى القيادة المطلقة.
زيارة ماكرون، والذي يعد أحد أكثر المؤمنين بـ"أوروبا الموحدة، إلى بريطانيا، بعد سنوات من خروجها من الاتحاد الأوروبي، تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حالة الشراكة، في الداخل القاري، وهو ما يعكس إدراكا عميقا بأهمية الدور الذي تلعبه بريطانيا، كأحد القوى الأوروبية البارزة، لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ووأد أي تهديد من شأنه إثارة الفوضى في داخلها، وهو ما يمثل مصلحة مشتركة لكافة أطراف المعادلة الأوروبية، بينما في الوقت نفسه، يعزز قدرة الاتحاد على إدارة علاقاته بمحيطه الجغرافي، عبر تنحية الخلافات جانبا، من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب في مواجهة محاولات صريحة لاستهدافه من قبل أقرب الحلفاء، وهو ما بدا أولا في ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، عندما دعم فكرة انشقاق لندن عن الوحدة الأوروبية، بينما امتدت الأمور إلى تجريد الحلفاء من المزايا الاقتصادية، عبر سياسة التعريفات، وتجاوزت السياسة والاقتصاد، عبر أبعاد أمنية أخرى، تجلت في الموقف الأمريكي غير المسبوق تجاه روسيا، على حساب أوكرانيا.
ولعل الأزمة التي لاحقت "أوروبا الموحدة"، منذ ميلادها في التسعينات من القرن الماضي، وخلال عقود ثلاثة تلت الحرب الباردة، تجلت في كونها أذابت سيادة دولها، لصالح الاتحاد، والذي أصبح دولة عابرة للحدود، في إطار حرية التنقل والتجارة والعملة الموحدة بين دوله، وغير ذلك من إجراءات تم اتخاذها لتعزيز حالة الوحدة، بينما فقدت هي نفسها سيادتها، كجزء من كيان أكبر، وهو المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، فصارت الوحدة الأوروبية أداة، تتوسع في أنحاء القارة (شرقا وغربا) للتضييق على روسيا.
تلك الحالة، ربما لم تكن مرضية بصورة كبيرة للندن، منذ اللحظة الأولى، وهو ما بدا، منذ عضويتها في الاتحاد، عبر رفضها أن تكون جزءً من منطقة "شنجن"، أو حتى في التخلي عن عملتها (الجنيه الإسترليني) لصالح اليورو، وهو الموقف الذي ربما ساهم بصورة أو بأخرى في تسهيل مهمة الرئيس ترامب "الأول"، للضغط على رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لدفعها نحو "طلاق" خشن من "أوروبا الموحدة"، مقابل الحصول على مزايا، ربما أبرزها تعزيز النفوذ البريطاني في القارة، من خارج الاتحاد، وعبر دور قيادي أكبر في الناتو، وهو الأمر الذي لم يتحقق، حتى عندما حل بوريس جونسون، والذي رآه غالبية المحللين امتدادا للخطاب "الترامبي"، على مقعد رئاسة الوزراء.
إلا أن خروج بريطانيا من الاتحاد، لا يعني خروجا من أوروبا، وهو الأمر الذي يدركه ماكرون، ومن وراءه القادة في بروكسيل، وبالتالي يبقى السبيل هو إعادة صياغة العلاقة بين الاتحاد والجوار الإقليمي، انطلاقا من بريطانيا، خاصة وأن الأخيرة تحمل الكثير من المواقف التي تتوافق بصورة كبيرة مع الرؤى التي تتبناها "أوروبا الموحدة"، خاصة فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا أو شكل العلاقة مع روسيا، ناهيك عن تقاربات أخرى، باتت أكثر وضوحا تجاه العديد من القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع في الشرق الأوسط، وهي كلها قضايا محورية، كانت المواقف القارية تصاغ فيها قبل سنوات داخل البيت الأبيض، إلا أن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى لندن، تعكس تغييرا مهما في الصورة التي ينبغي أن يدار بها الاتحاد، أو بالأحرى القارة ككل، في المستقبل، إذا ما أرادت أن تساهم في رسم الخريطة الجديدة للنظام العالمي.
وفي الواقع، إذا نجحت "أوروبا الموحدة"، في تعزيز شراكة حقيقية مع بريطانيا، عبر تحييد فكرة التنافس الإقليمي التي هيمنت على العلاقة بين بروكسيل ولندن، منذ "بريكست"، فليس من المستبعد أن يتم تطبيق النهج نفسه مع أطراف أخرى، ليست جزء من الاتحاد، ولكن لا يمكن لأحد أن ينكر "أوروبيتها"، وعلى رأسها روسيا نفسها، فإذا استطاعت القارة تعزيز استقلالها، فإنها ستتمكن من إدارة علاقاتها مع الأطراف كافة، بعيدًا عن قيود "المعسكر الغربي"، وهو ما يعني خلق مشتركات، حتى مع الخصوم، يمكن من خلالها تحييد الخلافات، أو حتى مناقشتها على طاولة الحوار، بعيدا عن دبلوماسية العقوبات، التي طالما انتهجها الغرب، والتي لم تؤدي إلى حلول، بل على العكس فاقمت من طبيعة الأزمات في العلاقة بين أوروبا وخصوم واشنطن.
الخروج من عباءة "المعسكر الغربي"، وقيوده والتزاماته، خاصة بعد المستجدات في العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة، أصبح السبيل للاستقرار الإقليمي في الداخل القاري، ومفتاح لدور أكبر على المستوى الدولي، في ظل ما سوف تحظى به من حرية حركة، اقتصرت في العقود الماضية على البضائع والبشر بين الحدود، ولكنها كانت عاجزة تماما على النطاق السياسي، في ظل الالتزام بالتحالف مع أمريكا وضرورة أن تتماهى المواقف الأوروبية مع رؤى البيت الأبيض، وهو ما يعني أن القارة العجوز ستستعيد "شبابها" الدولي، في لحظة فارقة، يشهد فيه النظام العالمي مخاضا، سيؤدي لا محالة إلى تغيير جذري في مستقبله.
وهنا يمكننا القول بأن زيارة ماكرون لبريطانيا، إن تم استغلالها بالصورة الصحيحة، قد تكون طفرة مهمة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، في ظل ما قد تسفر عنه من نهج قاري جديد في إدارة الإقليم، للانطلاق منه إلى تعزيز العلاقة مع العالم الخارجي، لتتحول القارة إلى أحد الفاعلين الدوليين الرئيسيين، وبالتالي تعزيز دورها فيما يتعلق بكافة القضايا الدولية الأخرى.
Trending Plus



 فيسبوك
فيسبوك
 واتساب
واتساب